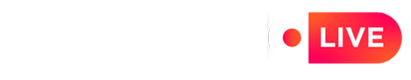في زمن تتسارع فيه التحوّلات وتتصادم فيه الاحتياجات مع الطموحات ينهار أحد أهم الأعمدة التي يستند إليها أي مجتمع وهي الأخلاق.
لم يعد الحديث عن “تغيّر الزمن” أو “اختلاف النفوس” مجرد مقولات شعبية تُقال لتفسير ما يحدث؛ بل أصبح واقعًا يلمسه الجميع في تفاصيل الحياة اليومية. فجأة، تحوّلت المصلحة إلى بوصلة وأصبحت الأخلاق خيارًا ثانويًّا يمكن التخلي عنه بسهولة حينما تتعارض مع مكسب أو فرصة أو خطوة للأمام.
اليوم، باتت العلاقات —سواء كانت صداقة أو عملًا أو حتى روابط عائلية— أكثر هشاشة من أي وقت مضى و يُكشف المعدن الحقيقي للناس في اللحظة التي تتعارض فيها مصالحهم مع التزام أخلاقي بسيط. كثيرون يتخلّون عن المبدأ من أجل منفعة، وعن صديق من أجل فرصة، وعن كلمة من أجل لا شيء تقريبًا. وهكذا تنتهي العلاقات ليس بصدامات كبرى، بل بخيبة صامتة تُمزّق الروح.
المشكلة لم تعد في وجود السلوك الخاطئ، بل في تعامل المجتمع معه.
أصبح كثيرون يبرّرون الأنانية على أنها “شطارة”، ويبرّرون الغدر بأنه “ذكاء اجتماعي”، بينما تُصبغ القسوة على أنها “واقعية”. ومع كثرة التبريرات تضيع الحدود بين الحق والباطل ويختلط ما هو طبيعي بما هو مشوَّه فيتحوّل الإنحراف الأخلاقي إلى أمر مألوف لا يُثير الدهشة.
ويبقى السؤال الأكبر من المسئول عن هذا الإنهيار؟ هل هو الفرد الذي قدّم مصلحته على حساب غيره؟ أم الأسرة التي لم تعد تمنح التربية الأخلاقية وزنها الحقيقي؟ أم المجتمع الذي بات يحتفي بالنجاح بغضّ النظر عن الطريق؟ أم وسائل التواصل التي ضخّت نماذج تُشجّع على الإستعراض والأنانية؟ الحقيقة أن المسؤولية مشتركة؛ فالأخلاق لا تسقط بسلوك فرد واحد، بل حين يتوقف المجتمع كله عن الدفاع عنها.
لم يعد الإنسان يقيس نفسه بما يقدّمه أو بما يحمله من قيم، بل بما يملكه وما يستطيع أن ينتزعه من الآخرين وتحوّل النجاح إلى سباق بلا قواعد، وصارت المكاسب أهم من الضمير وكأن معيار الإنسانية أصبح مرتبطًا بالحيلة لا بالنزاهة. ومع هذا التحوّل يتراجع الشعور بالذنب ويصير الخداع مجرد أداة للتقدّم، لا خطيئة تستدعي الوقوف عندها.
ومع مرور الوقت يتعوّد الناس على القسوة حتى تصبح جزءًا طبيعيًا من تعاملاتهم اليومية. يعتاد الفرد أن يمرّ على معاناة غيره دون أن يتوقف وأن يرى الظلم ولا يرفع صوته وأن يخذل من وثق به دون أدنى إحساس بالمسؤولية. إنها مرحلة يصبح فيها القلب أكثر صلابة من الواقع نفسه ويستطيع الإنسان أن يبرّر كل شيء حتى أكثر الأفعال انحطاطًا.
والمؤلم حقًا أن هذا السقوط الأخلاقي لا يحدث فجأة، بل يبدأ بخطوات صغيرة مثل كذبة تُقال دون ندم، ووعد يُنقض بسهولة أو موقف يُتخلّى فيه عن شخص محتاج ثم تتكرر الخطوات حتى يصبح الإنحدار نمط حياة. عندها يدرك المرء أنه لم يخسر الآخرين فقط، بل خسر صورته أمام نفسه؛ تلك الصورة التي كان يظن أنها ثابتة لا تتغيّر.
فسقوط الأخلاق لا يدمّر الأفراد فقط، بل يدمّر نسيج المجتمع بالكامل. مجتمع بلا أخلاق هو مجتمع بلا ثقة، بلا أمان، بلا روابط حقيقية. وفي غياب الأخلاق تتحول الحياة إلى ساحة صراع يتقدّم فيها الأقوى لا الأحقّ، والأجرأ لا الأصلح، والمتحايل لا المجتهد.
ورغم القتامة لا يزال الأمل ممكنًا حيث إن إعادة بناء الأخلاق تبدأ من الإعتراف بالمشكلة، ومن إحياء قيمة الضمير في تفاصيل الحياة، ومن إعادة التربية على احترام الإنسان لا على استغلاله. فالمجتمعات تنهض حين تتفق على أن الأخلاق ليست رفاهية، بل ضرورة للبقاء.
وفي النهاية يدفع المجتمع ثمن هذا الإنهيار من أمنه وسلامه الداخلي. فحين تنتشر الأنانية تتراجع الثقة، وحين يسود الغدر تضيع الطمأنينة وحين تذبل الإنسانية يتحوّل كل فرد إلى جزيرة معزولة لا تثق ولا تطمئن ولا تشعر بانتماء. وهكذا يفقد المجتمع جوهره وكأن المجتمع كله يتحول إلى ساحة صراع لا ينجو فيها إلا الأكثر قسوة.
مدرس بكلية الآداب – جامعة المنصورة.