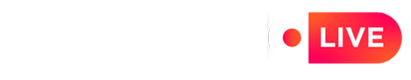في مساءٍ هادئ من أمسيات القاهرة، قبل أن يطوي القدر صفحة عميد المسرح العربي، كان يوسف وهبي يجلس في ركنه المفضل بمنزله، يحدّق إلى صورٍ تراصّت أمامه كجمهور وفيّ لا يرحل. كانت التجاعيد على وجهه تحمل نفس ملامح الأدوار التي عاشها: القوي المنكسر، العاشق الثائر، الحكيم الذي يضحك من الأعماق، والرجل الذي ارتدى قناع المأساة مثلما ارتدى عباءة الكوميديا. لم يكن مجرد ممثل… بل كان مسرحًا يمشي على قدمين.
وبجانبه كانت سعيدة منصور، آخر زوجاته وأكثرهن حضورًا في السنوات الأخيرة من حياته. لم تكن فقط رفيقة، بل كانت قلبًا يعرف كيف يحتوي صوته المتعب، وكيف يخفّف ضوء العيون حين يرهقه وهج الشهرة. ظلّت بجواره كما تبقى الستارة واقفة خلف كل بطل، تستره حين يتعب، وتكشف عنه حين يريد الوقوف من جديد.
وفي تلك الليلة، لم يكن يدري أن القدر يستعد لكتابة الفصل الأخير. تهاوى جسده فجأة في الحمّام، كجذع شجرة عظيمة تعب من الوقوف طويلًا. حملوه إلى مستشفى المقاولون العرب، والمدينة كلّها كانت تتهامس:
“يوسف وهبي… عميد المسرح… ألم يصمد دومًا فوق خشبة الحياة؟”
لكن القلب، ذلك العضو الذي طالما ضخّ مشاعر إلى أدواره قبل أن يضخّ دمًا لجسده، لم يحتمل. جاءت السكتة القلبية كستارة تسدل في لحظة لا يُعلَن فيها “مشهد تاني” ولا يُسمع فيها صوت مخرج. كان يوسف وهبي يغادر الدنيا بهدوء، وزوجته سعيدة منصور تمسك بيده، تعطيه رسالة الوداع التي لم تُقال بالكلمات.
رحل في ١٧ أكتوبر ١٩٨٢، لكن صدى صوته بقي فوق الخشبات، وفي ذاكرة جمهوره، وفي كل من عرف أن المسرح ليس مبنى… بل روح.
وفي الفيوم، حيث وُلد الفتى الذي صار “باشا” الفن وعميده، قرر محبّوه ألا يسمحوا للذاكرة أن تغفو. تأسست جمعية أصدقاء يوسف وهبي؛ بيتاً صغيرًا لفنانٍ كبير، وجسراً يربط ماضيه بالحاضر. وأمام مقر الجمعية، صُنع له تمثال يقف شامخًا كما كان دائمًا، كأنما التمثال نفسه يهمس للمارّين:
“إن الفن عمرٌ أطول من العمر… وإن الستارة لا تُسدل إلا على الجسد، أما الروح فتبقى تُنير المسرح.”
وهكذا، ظل يوسف وهبي—الرجل الذي عاش للمسرح ومات وهو يحمله في قلبه—حكاية لا تنتهي، وبطلًا لا يغادر المشهد الأخير.