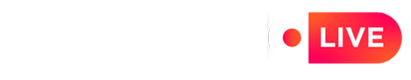مازالت الفنانة الكبيرة شمس البارودي تحيا بذكرياتها مع من كانت تُحب، تحيا بهم ومعهم وتعيد ذكرهم بأطيب ما كانوا عليه من إنسانيةٍ جميلة…
حسن… وروحٌ لا يغادر القلب مهما غاب الجسد
على صفحتها الشخصية فيس بوك كان موعدها مع متابعيها وأحبائها وأحباء زوجها الفنان الراحل الكبير حسن يوسف…
صباحُ الخير، وصباحُ الرضا بما قسمه الله، وحُسن التسليم لحكمه.
أتأمّل تلك الصورة التي جمعت ثلاثةً من أحبّتي ممّن سبقونا إلى دار البقاء… كانت آخرَ لَمّة كبيرة للعائلتين تحت سقف بيتنا؛ بيتٌ حمل من الدفء ما يكفي ليظلّ شاهدًا على المحبة، وعلى ما تبقّى من صدى أصواتٍ ما زالت تعيش في روحي.
أذكر كيف كان عبدالله، فلذة كبدي، حاضرًا يومها، بينما غاب في الصورة من رحلوا بعده تباعًا…
عادل، زوج شقيقتي ناهد، لحق بابني بأشهر قليلة في ٢٠٢٣…
ثم روح قلبي وشريك أيامي، حسن، الذي أخذ معه بهجة السنوات في ٢٠٢٤…
ثم اللواء منير يوسف، شقيق حبيبي، الذي رحل بعده بأقل من عام…
وكان منير أكثرَ من بكى يوم ودّعنا حسن؛ بكى كطفل فقد نصف قلبه، وحين رآني انهار مرددًا: “حسن راح… حسن راح يا حاجة”.
لَمّة رمضان الأخيرة… حين كان البيت يعج بالحياة
في ذلك اليوم أوصيتُ ابنه طارق: “خد بالك من بابا يا طارق… ده مكسور”، رغم أنّ الفاجعة كانت فاجعتي أنا، والخسارة كانت خسارتي وحدي.
ولمَ أحكي كلّ هذا؟
لأنّ الحياة—شاء الإنسان أم أبى—لا تمر دون أن تترك لنا عِبرًا تستحق أن تُروى.
منذ نشأة قصة حبنا… ثم زواجنا المبارك… كنّا أشدّ حرصًا على لَمّ شمل العائلتين؛ نلتقي في بيت حماتي وحماي، وفي بيت أبي وأمي، وفي المصيف، وفي الأعياد… لقاءاتٌ من دون مناسبة، ومن دون انتظار سبب.
نشأتُ أحب أسرتي وأقاربي جميعًا، وشاء الله أن يربطني بمن يشبهني في هذا الحب… فصار حسن متعلقًا بأهله كما أنا عالقة بقلبي بين أهلي.
لأن الذكريات لا تموت… تبقى البيوت شاهدة على المحبة
كنّا—بحمد الله—رأسَ الحربة في هذه العادة الطيبة.
عادةٍ تبني أجيالًا بصدورٍ رحيمة، تعرف حقّ الأرحام، وتعظم ثواب وصلهم.
وفي ذلك اليوم بالذات، يوم تلك الصورة، أرسلتُ الدعوة للعائلتين كاملتين.
لا أعلم لمَ فعلت هذا… لكنّ الحافز كان داخلي، يضغط على قلبي ليلتئم الجمع.
كان منتصف رمضان… ووافق عيد ميلاد حبيبي حسن.
امتلأ البيت بالشباب، الشرفات مفتوحة، التكييفات تعمل، لكن من يهتم؟
فالفرح حين يغمر القلوب… يعطّل كل شعور سوى الضحك والبهجة.
الكبار بين الصالونات والسفرة، والأمهات في الغرف يرضعن ويُغيّرن ويُطعمن…
كانت الصورة حياةً صافية، مكتملة.
وبعد الإفطار، أفسحنا السفرة لـ تورتة عيد ميلاد حبيبي، كما اعتدنا كل رمضان…
لم أجهد نفسي يومًا في إعداد الأطباق الثقيلة، فكل من يدخل البيت كان يحمل طعامًا.
وكنت أنادي مساعدتي: “هاتي أطباق لأحبابنا تحت… دول ليهم ثواب الجمع المبارك ده”.
وأعود فأقول:
لم تُبنَ بيوتنا للفرجة، ولا لتحنيط الأثاث.
ما المشكلة إن سقط طبق، أو اتّسخ السجاد، أو لعب الأطفال فوق الكنب؟
كلّه يُغسل، يُنظّف، يُستبدل…
لكن فرحة اللّمّة، تلك لا تُعوّض، ولا تُغسل من الذاكرة.
أحمد الله أنّنا لم نكن منغلقين ولا بخلاء بالمحبة.
لم تكتمل سعادتنا يومًا إلا بمشاركة أهلنا، حتى وإن كانوا في رغدٍ من العيش…
لكن المشاركة كانت عين الحب، وتمام العطاء.
فصلة الرحم ليست هاتفًا سريعًا، ولا زيارة واجب…
صلة الرحم حياةٌ كاملة، فرحةٌ تُكسِب العمر بركة، وتملأ البيوت نورًا، وتُبقي القلوب معلّقة بالسماء.
أستعيد اليوم تلك الذكريات… وأشعر أنّ يدًا رحيمة تُربّت على قلبي، كأن الله يقول لي:
ما دام الحب كان لله… فلقاؤكم عند ملك الملوك آتٍ لا محالة.
يومٌ جميل عليكم… وذكرياتٌ أجمل، بإذن الله.