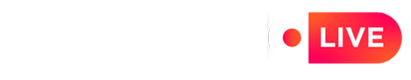في صباحٍ قاهريّ دافئ من صيف 1926، وُلد طفل حمل ملامح تشبه نبرة موسيقى قادمة… طفل سيكبر ليصبح سعد عبد الوهاب ذلك الوجه الهادئ الذي خُلق وعلى جبينه ظلّ من عباءة عمه محمد عبد الوهاب، وكأن القدر كتب عليه أن يسير في الطريق نفسه، ولو بعد حين.
كبر سعد في بيت يمتلئ بالمقامات الموسيقية والكتب القديمة ونفَسٍ محافظ يراقب حركة الحياة من بعيد. وما إن شبّ عن الطفولة، حتى حمل كتبه إلى كلية الزراعة، يظنّ أن طريقه سيكون بين الحقول لا بين الألحان. تخرّج عام ١٩٤٩، وحصل على وظيفة حكومية في نجع حمادي… لكنه ما إن وقف بين الأرض والتراب عشرة أيام، حتى أدرك أن قلبه لا يسمع النداء هناك، بل يسمعه في مكان آخر… في عالمٍ لا يُزرع بالمحراث، بل بالنبضة الموسيقية الأولى.
ترك الوظيفة، كمن يخلع عباءة لا تشبه جلده، واتجه إلى الإذاعة المصرية. هناك، عرف صوته طريقه إلى الناس قبل أن يعرف طريقه إلى السينما. وكان على وشك أن يتراجع أمام خوف المجتمع ونظرات الناس، لولا زيارة واحدة غيّرت كل شيء…
دخل على الشيخ محمود شلتوت، يسأله عن الفن: حلالٌ أم حرام؟
فنظر الشيخ إليه، ورأى شابًا لا يريد دنيا ضائعة، بل بابًا يليق بقلبه، وقال له:
“يا سعد، ليس هناك حرامٌ أو حلال في المطلق… الكلمة هي الميزان. فإن سمت بالناس، فما الذي يُعاب فيها؟”
كانت تلك الكلمات رخصة عبور… شهادة ميلاد جديدة، فخرج سعد منها وفي يده بوابة الفن، وفي قلبه عهدٌ ألا يغنّي إلا ما يرضي ضميره.
وفي العام نفسه، كان القدر يفتح له نافذة أخرى…
اكتشفه المخرج حسين فوزي، ورأى فيه وجهًا جديدًا تصلح ملامحه لرواية الحكايات. قدمه أمام النجمة الصاعدة نعيمة عاكف في فيلم “العيش والملح”، فكان بدء الرحلة.
ثم توالت الأفلام:
أختي ستيتة، سيبوني أغني، بلدي وخفة…
وفي كل فيلم، كان سعد يشبه نفسه، لا أحدًا غيره. هادئًا، خجولًا، يحمل البراءة في عينيه كأنها لازمة موسيقية لا تفارقه.
عام 1951، وقف أمام تحية كاريوكا في فيلم “بلد المحبوب”، وكانت تلك خطوة أخرى تؤكد أنه لم يدخل الفن صدفة… بل لأن الفن هو الذي اختاره.
ثم جاء فيلم “أماني العمر” عام 1955، من إنتاجه، وفيه غنّى لأول مرة من ألحانه. بعدها، احتاج أن يستريح، عامان من الصمت، كمن يستجمع أنفاسه قبل القفزة الأخيرة.
ثم جاءت القفزة…
فيلم “علّموني الحب”، الذي أصبح أيقونة، لا لقصته فقط، بل لأنه حمل أغنية ستظل عالقة في السماء:
“الدنيا ريشة في هوا”
غناها سعد وكأنه يغني سيرته… كأنه يكتب على لسان عمره أن الإنسان مهما ظنّ نفسه ثابتًا، فهو في النهاية ريشة… تمضي حيث تهبّ رياح الأقدار.
نجح الفيلم، لكن شيئًا داخله كان قد تعب. ربما الجهد، ربما الحساسية، ربما ذلك الخيط الدقيق الممتد بين الفن والورع. رفض بعدها عشرات الأفلام، مقتنعًا أن قلبه لن يخونه إن هو التزم بالكلمة العفيفة.
غنّى بعد ذلك قليلًا…
على فين واخداني عينيك، القلب القاسي، من خطوة لخطوة…
وأعطى من ألحانه لمحمد قنديل وصباح وشريفة فاضل وفايدة كامل وغيرهم…
لكن رغم هذا كله، ظلّت الموسيقى عنده حالة خاصة… نعمة يخشاها بقدر ما يحبها.
ومثلما ورث عن عمه موهبة الفن، ورث عنه شيئًا آخر…
الوسوسة.
الخوف من البرد.
الحرص المبالغ في النظافة.
كان يرفض أن يأكل خارج بيته، وكان يعيش بشيء من الحذر كأن العالم أكبر من احتماله.
ثم فجأة…
اختفى.
ترك القاهرة، وسافر بعيدًا إلى السعودية، ليعمل مستشارًا بالإذاعة. كان يحتمي من وهج الأضواء، يفضل العزلة الهادئة على ضجيج النجومية.
ثم انتقل إلى الإمارات، وهناك كتب موسيقاه على صفحة وطنٍ كامل، حين لحن السلام الوطني الإماراتي وغناه بصوته.
لكن الحنين كان أقوى…
فعاد إلى القاهرة، إلى بيته، إلى زوجته، إلى ابنيه “هاني وعمرو”، وعاش بعيدًا عن الوسط الفني أكثر من عشرين عامًا…
كأنه قرر أن يكتفي بما قدمه، وأن يترك خلفه أثرًا نظيفًا، بلا صراع، بلا تنازل.
وفي 23 نوفمبر 2004، أُغلق الباب الأخير…
رحل سعد عبد الوهاب بهدوء يشبه حياته، تاركًا خلفه أفلامًا قليلة، وأغنيات قليلة، لكن روحًا كبيرة… وروائع لا تزال تتردد كنسيم لطيف على ذاكرة الزمن.
ومع أنه كان دائمًا يخشى البرد…
إلا أن صوته ظل دافئًا،
وما زالت الدنيا — كما غناها —
“ريشة في هوا”…
تتذكره كلما هبّت عليها موسيقى نقية القلب.