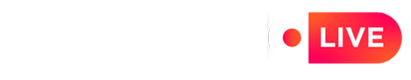خلفَ الهدوءِ.. ملامحٌ أُخرى ويظن المرء منا أحياناً أن الصمت انتصار، وأن تجرع الغصات دون أنين هو قمة القوة. لكن الحقيقة المرة التي ندركها متأخرين هي أن الكتمان هو أكبر هزيمة قد نرتكبها بحق أنفسنا. تلك الأحزان التي نراكمها في الزوايا المعتمة من أرواحنا لا تموت، بل تتحول ببطء إلى ألم جسدي ينهش الملامح، ووهن يثقل الأطراف؛ نحن لا نكتم الحزن، نحن ندفنه حياً داخلنا ليأكل من عافيتنا.
هذه الهشاشة التي نغلفها بالصمت، تزداد حدة حين نصطدم بحقيقة أن من حولنا لا يرون منا سوى القشور. إياك أن تظن يوماً أنك تعرف شخصاً ما تمام المعرفة، أو أنك ملم بدوافعه وأسرار شخصيته. نحن نحكم على الآخرين من منطلق تصوراتنا، ونؤطرهم في إطارات لا تشبههم، متناسين اليقين الذي يقول: “في كل إنسان تعرفه إنسان لا تعرفه”. خلف كل وجه شاحب قصة لم تُروَ، وخلف كل نبرة صوت حزينة ندوب لا تمحوها الأيام.
لقد تغلغل الحزن في تفاصيلنا حتى غدا منهجاً وروتيناً مسيراً. نفتح أعيننا كل صباح على صراخ الفقد، ونظرات الأمهات المنكسرة، وصور الرحيل التي تملأ الأرصفة. لقد امتد الوجع من المعاجم والكلمات ليصل إلى أطراف أصابعنا؛ تلك الأصابع التي كلما حاولت الإمساك بطرف خيط للحياة، استحال في يدها سلكاً شائكاً يدمي القلب قبل الكف. صرنا نرتضي بـ “نصف حياة”، ونرضى بالفتات في كل شيء، إلا في “طبق الوجع”، فقد نلنا حصتنا كاملة غير منقوصة.
وفي محاولة أخيرة للنجاة من سحق هذه المشاعر، يهرب الواحد منا إلى “العمل”. ليس رغبة في الإنجاز، بل رغبة في الغياب. أن نبقى مشغولين للحد الذي يلهينا عن تعاستنا، ويمنعنا من سماع صوت تحطم أرواحنا في الداخل. إننا نركض في مضمار الحياة لا لنصل، بل لكي لا نلتفت خلفنا ونرى مقدار ما فقدناه من أنفسنا.
هذه ليست مجرد كلمات، بل هي دعوة لتدرك أنك لست وحدك في هذا الضيق، وأن الصمت الذي تظنه حصناً، هو في الحقيقة زنزانة أنت سجانها.