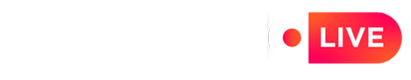هناك أمثال شعبية مازالت رغم مرور القرون تحمل في داخلها رائحة زمنٍ كان يفضّل الصوت الخشن على الهمسة الرقيقة، ويحتفي بقدوم الذَّكر كما لو أنه فارس منقذ، بينما يستقبل الأنثى باستحياءٍ أو خيبةٍ أو تهرّبٍ من التهاني، أمثالٌ ترتدي ثوب الجاهلية، وتُخفي في نسيجها خيوطًا من التمييز والغبن، وتُردَّد على الألسنة حتى باتت جزءًا من حكاية المجتمع.
هذه الأمثال ماهى إلا عقل جمعي يُعاني من ترسّبات قديمة. ويكفي أن نستمع إلى قولهم:
«أبشروا أم الدكير بالخير»
وهو مثلٌ يُقال لامرأة أنجبت ذكرًا، وكأن الخير لا يُنزل إلا مع المواليد الذكور، وكأن الفرح لا يبزغ إلا في صوت الصبي!
ثم ننتقل إلى المثل السوداني الذي ترويه عائشة السودانية:
«والبنات ما فيها خير»
مثل قاسٍ، يختصر الأنثى في نظرة ضيقة لم تعرف من النساء إلا الضعف، ولم تُدرك أن البيوت قامت على أكتاف أمهات وجدّات، وأن المجتمعات نهضت بعلم بناتٍ حملن بالمحابر ما لم يحمله كثير من الرجال.
ليس غريبًا أن نجد هذه الأمثال منحازة لإنجاب الذكور؛ فهي ميراث جاهلي قديم، يرى الأنثى كمالًا ثانويًا، ووجودًا يمكن الاستغناء عنه، بينما يقف الذكر في المثل الشعبي كقيمةٍ عليا ونجاة متوهَّمة.
ويا للعجب…!
رغم أن الإسلام جاء فهدم هذا الجدار كله، ورفع شأن المرأة، ومنحها حقها في الكرامة والميراث والعلم والتملك، إلا أن هذه الأمثلة ما زالت تتسلل إلى أذهان بعض الناس، وكأنهم يعيشون بين زمنين؛ أحدهما نورٌ، والآخر ظلٌّ قديم لا يريد أن يزول.
إن إنجاب الذكور والإناث ليس فضلًا من بشرٍ على بشر، بل هو حكمةٌ ربانية، وتقديرٌ إلهي لا يعلمه إلا الله. وقد حسمت سورة الشورى (الآية ٥٠) هذا المعنى بوضوحٍ وجمال، إذ يقول تعالى:
﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾
آيةٌ تعيد ترتيب الوعي، وتضع الحقيقة في مكانها:
الولد هبة… والبنت هبة… والعقم هبة… كلها تقديرٌ من رب قادر حكيم، لا فضل فيها لأحد على أحد.
مع الزمن، بدأت أصوات الوعي ترتفع، وأقلامٌ جديدة تكسر تلك القوالب المهترئة، وتعيد الاعتبار للأنثى التي ظُلمت طويلًا بتلك الأمثال. فالبنات لسن “عبئًا”، ولا “نذيرًا للشقاء”، بل مصدر رقة، وعقل، وعطاء، وقيمة إنسانية لا تُقدَّر بثمن.
مهما طال عمر الأمثال، سيأتي يوم تُصبح فيه مجرد أثرٍ من ماضٍ تجاوزه الوعي، ويقف الناس على الحقيقة التي قالها القرآن، ورددتها التجارب، وكتبتها الحياة:
إن البنات… والذكور… جميعهم من نفخة روحٍ واحدة، وكرامة واحدة، وقيمة واحدة… فلا فضل لأحدهم إلا بالتقوى والعمل.
الغريب أنه في ذاكرة الشعوب، تختبئ الأمثال مثل مرايا صغيرة تعكس وجوهنا القديمة؛ وجوه آبائنا وأمهاتنا، وأفكارًا سكنت الأزقة الريفية والحواري الشعبية قبل أن تسكن عقول الناس ولأن المثل الشعبي ابنُ الواقع، فقد حمل معه انحيازاته القديمة، فأعطى للولد عرشًا مفترضًا، وللبنت هامشًا ظنّوه أقل قيمة، هكذا وُلدت تلك الأمثال التي ميزت بين الجنسين، لا لأنها حقيقة، بل لأنها رواسب زمنٍ كان يرى في الذكر سندًا، وفي الأنثى عبئًا أو مسؤولية.

تسمع عجوزًا على عتبة دارها تقول: “الولد عزوة… والبنت همّ للممات”، وكأن الأنثى ليست روحًا تُفرِح وتُبهج، بل عبء يبدأ بصوت بكائها ولا ينتهي إلا حين تغادر بيت أهلها وتردد أخرى: “ضل راجل ولا ضل حيطة”، لتُثبت في الوعي الشعبي أن قيمة المرأة لا تكتمل إلا بظل رجل، مهما كان ضعيفًا. أمثال ترسّخت في الذاكرة الجمعية، لا لأنها عادلة، بل لأنها تكررت حتى صارت مألوفة مثل أغنية قديمة تُعاد بلا تفكير.
لكن الزمن تغيّر… والقلوب تغيّرت… وأصوات كثيرة قررت كسر هذه السطور المتوارثة.
ومن بين تلك الأصوات، خرج صوتٌ مُبهج يشبه سحر الطفولة… صوت سعاد حسني وهي تغنّي:
“البنات… البنات… ألطف الكائنات.”
لم تكن مجرد أغنية، بل كانت إعلانًا مبكرًا لثورة ناعمة على الأمثال التي ظلمت البنات طويلًا. أعادت الأغنية تعريف الأنثى ككائن يملأ البيت ضحكًا، ويرسم للحياة ألوانًا، ويمنح العالم رقةً وبهجة.
جاءت الأغنية كصفعة رقيقة على وجه الثقافة التي حصرت الأنثى في الخوف والقلق والحذر، لتقول إن البنات ليسوا “همًّا”، ولا “نقمة”، بل قوة جمالٍ ونعمة ودفء لا يُعوَّض.
إن الأمثال التي تفضِّل الولد على البنت ليست سوى آثار لثقافة كانت تختبئ خلف الحاجة الاقتصادية، والخوف من قسوة الأيام.
كانت ترى في الولد يدًا عاملة، ومستقبلًا يستند الأب إليه، أما البنت فكانت تُحمَّل بتوقعات المجتمع ومعاييره الصارمة لكن الحقيقة التي يرويها التاريخ والواقع أن البنات كُنّ —وما زلن— سندًا، وعمادًا، ورعاية، وطمأنينة… بل إن الكثير من قصص الوفاء والنجاح والبطولة كانت بطلاتها نساء تفوقن على الرجال عقلًا وقلبًا وصبرًا.
اليوم، ومع تغيّر الزمن واتساع أبواب العلم والعمل، تتهاوى تلك الأمثال القديمة مثل جدران طينية ضربتها أمطار الوعي.
لم تعد البنت تُقاس بزواجها، ولا بقيمة مهرها، ولا بظل رجل يحميها… بل بقدر تعليمها، ونجاحها، ووعيها، وقدرتها على صناعة ذاتها ومستقبلها.
يبقى السؤال:
هل ما زال بيننا من يردد تلك الأمثال؟
ربما نعم… لكن أصواتًا جديدة ترتفع، أغنيات ومبادرات وقصص نجاح، تُعيد للبنت حقها في الاحترام والفخر والإنصاف.
بين الأمثال القديمة والأغاني الحديثة، يبقى صوت سعاد حسني يلمع مثل زهرة على شرفة القلب، يذكّر كل من يسمعه بأن الأنثى ليست “رقمًا زائدًا” في دفتر الحياة، بل روحًا كاملة… لطيفة… خفيفة… تسمو بالبيت والمجتمع.
لتبقى الحقيقة واضحة كما قالتها السندريلا:
“البنات… ألطف الكائنات.”